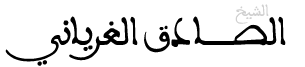|
بسم الله الرحمن الرحيم حرمة الأموال: حرمة الأموال من المقاصد الكلية في ملة الإسلام، والحفاظ عليها إحدى ضرورات الشريعة الخمسة؛ الدين والنفس والمال والعقل والعرض، ولحرمتها والحفاظ عليها حرم الله تعالى أكل المال بالباطل فقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ)، وشرع قطع اليد في السرقة، فقال تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ)، وشرع حد القتل في الحرابة فقال تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ)، وحرم الغصب والمغالبة على الحقوق، ففي الصحيح من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (مَن اقْتَطَعَ شِبْرًا مِن الأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ الله إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ)، وشرع ضمان الإتلاف والتعدي، فقال صلى الله عليه وسلم: (عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ)، وقد عظم النبي صلى الله عليه وسلم الأموال كما عظم الدماء، فقال وهو يودع الناس يوم عرفة في حجة الوداع: (... فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا)، وقال: (كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ؛ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ)، وعنه صلى الله عليه وسلم قال: (إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه)، وقال عن الذي عزم على أخد مال أخيه بيمين كاذبة: (ليلقين الله وهو عنه مُعْرِض). ولئن كانت التوبة تَجُبُّ ما قبلها وتمحوه، والجهاد يهدم ما قبله، والحج المبرور يهدم ما قبله، فإن ذلك كله وأمثاله مما ورد في السنة يستثني الدين ويستثنى الحقوق التي بين الناس، فإنها لا يهدمها ولا يمحوها ولا تصح التوبة منها إلا بالتحلل من أصحابها، والناس يُحبسون يوم القيامة على الصراط حبسا يخاف منه الناس جميعا، حتى إن دعاء الأنبياء يومئذ: (اللهم سلم سلم)، وذلك ليتقاصوا الحقوق والمظالم، فلا يُنجِي من هذا الموقف الصلاة والصوم والحج إن أخل العبد بحقوق العباد، فإن الله تبارك وتعالى جواد كريم يعفو ويصفح عن حقه بالتوبة والإنابة إليه، أما العبد فالتوبة من حقوقه لا تتم إلا بإذنه، وإلا فليس إلا القصاص يوم لا درهم ولا دينار، ولا تخالص إلا بالحسنات والسيئات، جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِن النَّارِ حُبِسُوا بِقَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيَتَقَاصُّونَ مَظَالِمَ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا، حَتَّى إِذَا نُقُّوا وَهُذِّبُوا أُذِنَ لَهُمْ بِدُخُولِ الجَنَّةِ). وهذا الحكم في الحقوق وحرمتها والقصاص منها عام على الناس جميعا، تابعين ومتبوعين، رؤساء ومرؤوسين، ولاة أمور ومأمورين، لم يستثن من قاعدة المظالم هذه أحد، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاشاه أن تكون في عنقه مظلمة لأحد، لكنه في آخر أيامه صلى الله عليه وسلم وقف بين أصحابه ليُشَرِّع ويَسُن لولاة الأمر من بعده فقال: (أيها الناس، ألا إنه قد دنا مني حقوق من بين أظهركم، فمن كنت جلدت له ظهره فهذا ظهري فليستقد منه، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه إلا، لا يقولن رجل إني أخشى الشحناء من قبل رسول الله، ألا وإن الشحناء ليست من طبيعتي ولا من شأني، ألا وإن أحبكم إلي من أخذ حقا إن كان له أو حللني فلقيت الله وأنا طيب النفس، ألا وإني لا أرى ذلك مغنيا عني حتى أقوم فيكم مرارا). كما أن القاعدة العامة في تحمل التبعات ومسؤولية التصرفات في الشريعة، أن كل إنسان مسئول وحده عن تصرفات نفسه، لا يغني فيها أحد عن أحد، لا مدير ولا وزير ولا أمير، حكم عام للمسلم والكافر والصالح والعاطل والصديق والعدو والوالد والولد والصاحبة بالجنب، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا)، وقال عز وجل: (يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ)، وقال: (وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى)، وقال: (إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ)، وقال: (وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ)، وقال: (وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلا). نزع الملكية للمصلحة العامة: حتى ما ينزع من الملكية للمصلحة العامة ليس فيه استثناء، هو داخل فيما سبق من عموم الأدلة على حرمة الأموال، شرطه الرضا والتعويض العادل بالثمن المجزي بسعر الوقت، وليس بما يفرضه القانون من التسعير بنصف القيمة أو ربعها أو عشرها، رضي من رضي وكره من كره، فنزع الملكية للمصلحة العامة مشروط بشرطين: الأول ـ إعطاء القيمة الحقيقية للأملاك المنزوعة، والثاني ـ رضا أصحابها. ولا يصح نزع الملكية عند عدم تعنت أصحابها دون تحقيق هذين الشرطين، فقد أخرج البيهقي في السنن وغيرُه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: (كانت للعباس دار إلى جنب المسجد في المدينة، فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بعنيها أو هبها لي، حتى أدخلها في المسجد، فأبى، فقال: اجعل بيني وبينك رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلا بينهما أبى بن كعب، فقضى للعباس على عمر ... فقال العباس: أليس قد قضيت لي بها وصارت لي؟ قال: بلى، قال: فإني أشهدك أني قد جعلتها لله)، وفي رواية ابن سعد أن عمر قال: (فبعنيها بما شئت من بيت مال المسلمين أوسع بها في مسجدهم) الإكراه الشرعي على نزع الملكية: قد يتعنت صاحب الحق الذي أريد انتزاع الملكية منه للمصلحة العامة ويأبى مع بذل أضعاف قيمة حقه، وتعنته يضر بالمصلحة العامة للأمة، فالجبر في هذه الحالة على البيع مشروع، تقديما للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وهذا من الإكراه الشرعي، والإكراه الشرعي يعد كَلاَ إكراه، لقيام رضا الشرع مقام رضا المالك، لأن الشرع أرحم بالعباد من أنفسهم، وذلك مثل المدين لا يجد وفاء لدينه، ولا يريد بيع ماله، فيُجبره القاضي على بيع بعض أملاكه ليخلص الغرماء، ومثل جبر من له دار أو أرض تلاصق مسجد الجمعة أو الطريق ـ على بيعها لتوسعة المسجد أو الطريق، بشرط أن تكون الطريق عامة لكل الناس وليست خاصة لبيوت بعض الناس. وهذا لا يكون إلا بعد أن تقوم الجهات المختصة في الدولة بفعل ذلك، وليس للناس أن يشقوا الطريق التي يحتاجون إليها من أرض الغير بأنفسهم، ولا يجوز لأحد المرور منها قبل قيام الدولة ذلك إلا باستحلال صاحبها، ويُدفع ثمن الطريق التي أخذت للمصلحة العامة من بيت المال، كما فعل عثمان رضي الله عنه عند توسيعه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في الإكراه الشرعي وأنه لا يعد إكراها ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لليهود: (إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ، فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِعْهُ، وَإِلا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا الأَرْضُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ). فقد أكرههم رسول الله صلى الله عليه وسلم على البيع، ويقاس عليه كل إكراه شرعي صحبه تعنت صاحب الحق، فإنه نافذ. وما فعله عمر مع العباس من التسامح معه وتوقفه عن ضم داره إلى المسجد حتى رضي، ولم يُجبره مع ظهور المصلحة في الجبر، هو من عمر زيادة ورع وتحوط مع عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما توسمه عمر بفراسته وبصيرته أن الأمر سينتهي إلى ما انتهى إليه من بذل العباس داره عن طيب نفس منه لله ورسوله. إعطاء القيمة الحقيقية عند عدم التعنت غير كاف حتى ينضم إليه رضا المالك، لأن إعطاء القيمة الحقيقية أحيانا لا يفي بالغرض، كأن يكون المنتزع ملكيته يتعذر عليه الحصول على بديل مناسب، لعدم توفره على الإطلاق أو لعدم وجود وجه مرخص له به يحميه فيه القانون من الهدم أو انتزاع الملكية مرة أخرى، أو وجوده ولكن بكلفة تفوق التعويض الذي تحصل عليه المتضرر، أو يصيب من انتُزعت ملكيته ضرر كبير كما في هدم المراكز التجارية قبل إيجاد بديل تجتمع فيه أصحاب هذه المراكز لتسيير أعمالهم، أو عدم إعطائهم مدة كافية للإخلاء والحفاظ على ممتلكاتهم حتى لا تتعرض للإتلاف بسبب سوء التخزين أو النقل أو غير ذلك من الأضرار ـ هذه المحاذير وغيرها التي قد يتعرض لها من انتُزعت ملكيته للمصلحة العامة هي السبب في أن التعويض بالقيمة الموافقة لسعر السوق وحدها قد لا تكفي في إعطاء الحق بنزع الملكية حتى ينضم إليها الرضا بالتعويض المبذول. ومن تسبب في إتلاف أموال الناس وانتزع أملاكهم على غير الوجه المشروع المشروط ببذل القيمة الحقيقية والرضا عند عدم التعنت ـ هو ضامن لما أتلفه، ويتحمل كامل المسؤولية الشرعية القائمة على الضمان والقصاص، والعمد والخطأ في باب الضمان سواء، ولا يُعذر من فعل ذلك مكرها أو أنه يُنفذ ما أمر به، إلا أن يكون الإكراه مُلْجِئًا، بأن هُدِّد المُكرَه بقتل، أو تعذيب، يُفضي إلى إتلاف عضو أو حاسة من حواسه، ولا يُلتفت إلى مجرد التهديد بالحبس والضرب، فلا يُعدّ به الفاعل مكرَها معذورا في إتلاف أموال الناس. وكذلك خوفُ العزل من المنصب والوظيفة لا يُعد إكراها مُلجئا يبرر إتلاف مال الغير دون وجه حق. والضمان في الإكراه على المُكْرِِه إن كان الإكراه مُلْجِئًا، هذا ما قرره أهل العلم في هذه المسألة العظيمة القدر والخطر، والله تبارك وتعالى أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني 17 ربيع الأول 1431 هـ الموافق 3 / 3 / 2010 |